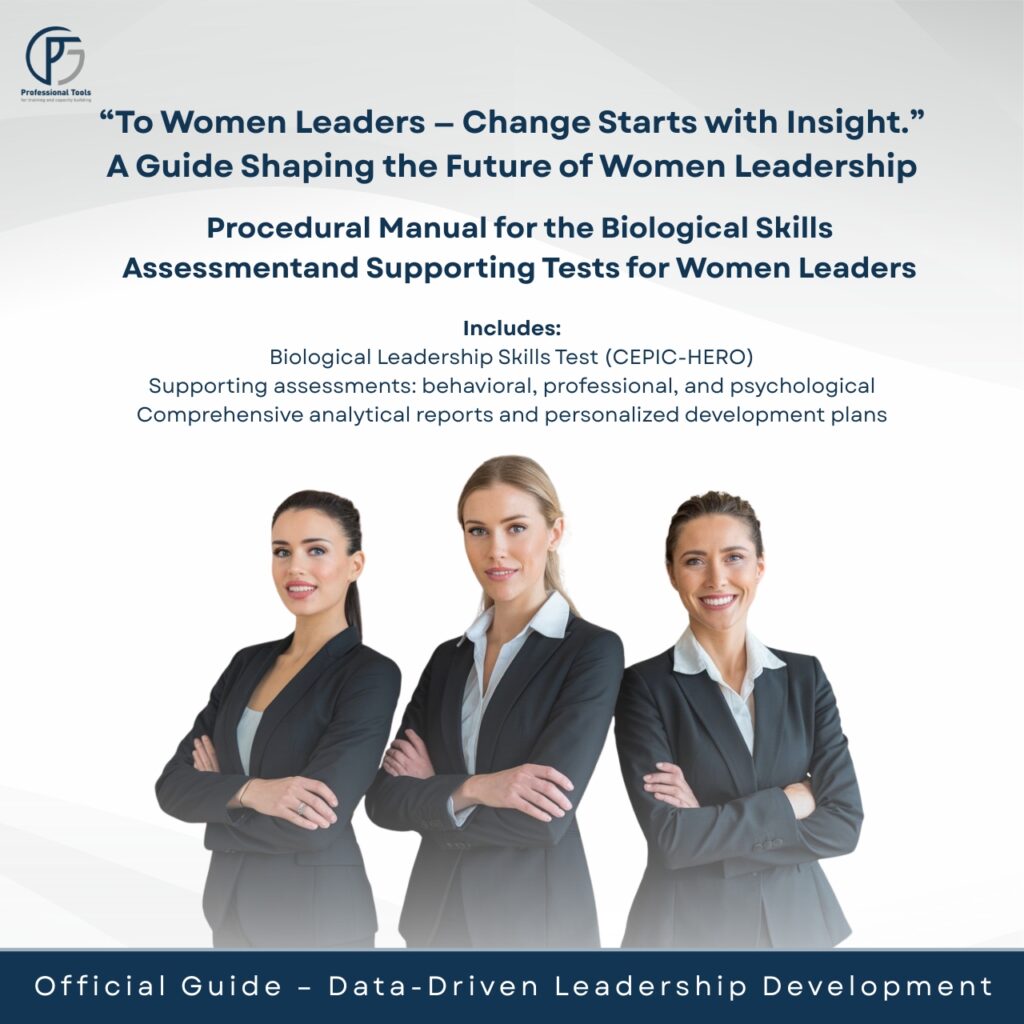الدورات والتدريب
الظل كذاكرة للضوء: قراءة في رواية ظل الملكات للدكتورة ميسون تليلان
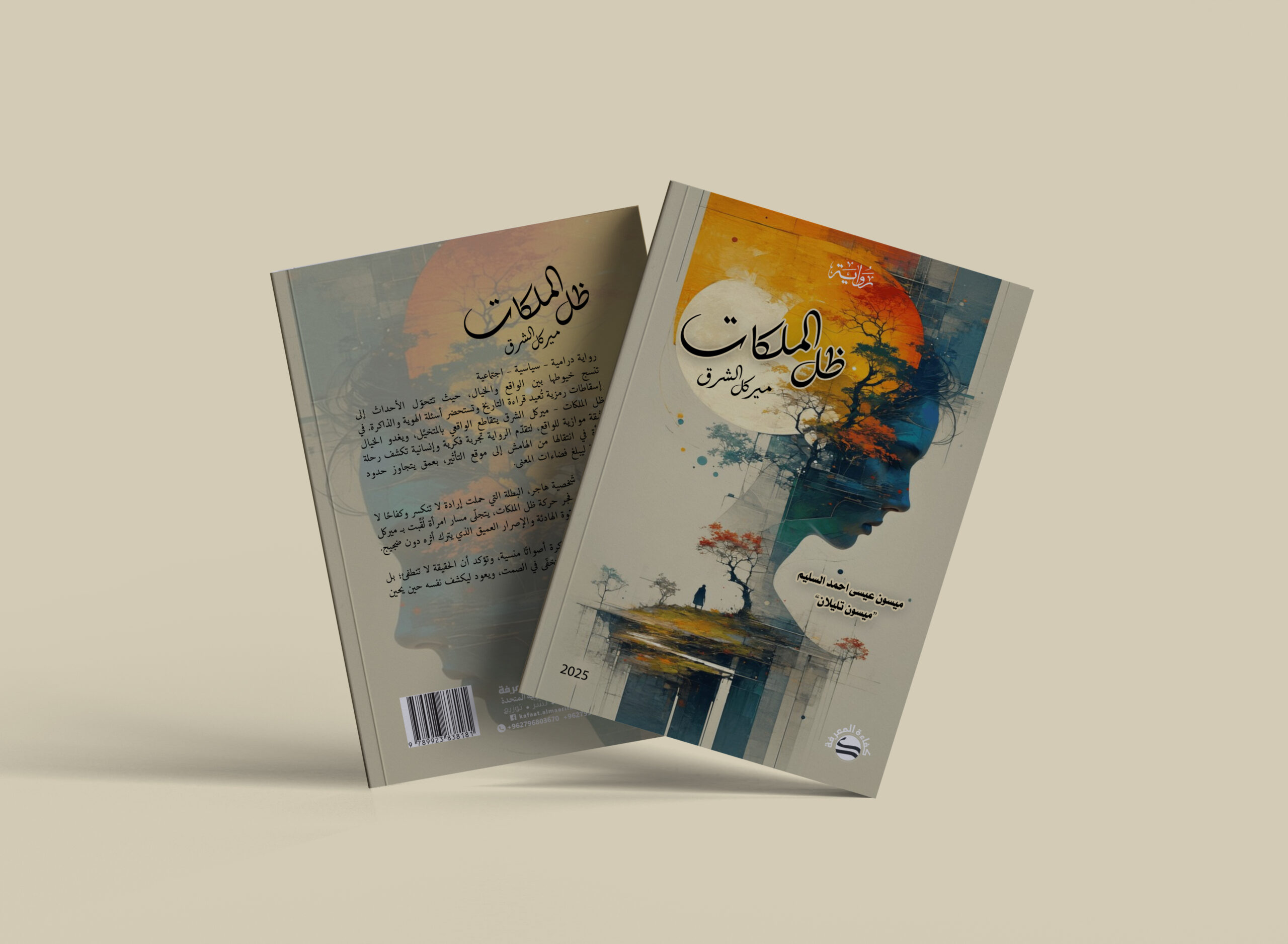
أ.د.عبد المنعم همت
مدخل: تتبدّى رواية (ظلّ الملكات) كعملٍ يتجاوز حدود السرد التقليدي، لتغدو فضاءً تأمليًا مفعمًا بتوتّرات الذاكرة والهوية، ومشبعًا بإيقاعات الأسئلة الكبرى عن الوجود والأنوثة والسلطة والمعنى. ليست الرواية مجرّد حكاية عن نساءٍ في مواجهة واقع اجتماعي وسياسي متكلّس، بل هي إعادة تشكيل للوعي الجمعي من خلال مرآة الفرد الأنثوي الذي يتحرّك في فضاء من القمع والتواطؤ والصمت. ومنذ الفصل الأول، تنفلت الرواية من نمط الحكاية إلى نسق الكشف، فهاجر ـ بطلتها المركزية ـ لا تُقدَّم بوصفها شخصية تبحث عن خلاصٍ شخصي، بل كصوتٍ يُستدعى من ظلال التاريخ لإعادة كتابة السطور التي محاها الآخرون عمدًا.
يبدأ النص من حركةٍ صغيرة ـ (خطوة) على طريق رماديّ، بين زحام السوق وغبار الشوارع ـ لكنها سرعان ما تنقلب إلى إعلان وجودٍ يتحدّى الإنكار. هذه البداية ليست مجرد افتتاحٍ حكائي، بل هي مشهد ولادة رمزية لوعيٍ نسويّ جديد، يخرج من طين الواقع ليواجه النظام الذكوري المتجذر، ويتحوّل إلى مشروع مقاومة فكرية تتّخذ من الكلمة سلاحًا ومن الإصرار جذورًا. إنّ هاجر ليست امرأة عادية؛ إنها كيان يتشكّل من هشاشة التجربة وقوّة الفكرة، من خوفٍ يُنضج الإيمان، ومن عزلةٍ تُثمر الحضور. ولذا فإنّ لحظة خروجها من بيتها ليست خروجًا ماديًا، بل عبورًا رمزيًا من الهامش إلى المتن، من التلقي إلى الفعل.
تقدّم الكاتبة عبر هذه اللحظات الأولى بناءً سرديًا يقوم على الاستنبات الفكري قبل أي تحول درامي، فالفصل الأول يشبه بذر الفكرة في تربة جافة، حيث يُختبر الوعي في مواجهة الخوف، ويُقاس الإيمان بقدرة البطلة على مواجهة الانسحاب والخذلان دون أن تفقد يقينها بالمسار. إنّ النص لا يحتفي بالبطولة بمعناها البطوليّ الصاخب، بل يخلق بطلةً مضمّخة بالصمت والإصرار، تسير بين الناس دون لافتة، لكنها تحمل مشروع التغيير في عينيها، مشروعًا يعيد للمرأة حقّها في أن تكون ذاتها، لا ظلًّا لأحد.
ومع توالي المشاهد، تتكشّف البنية العميقة للرواية: صراع بين الصوت والظلّ، بين الذاكرة الممحوة والتاريخ المكتوب بيد المنتصرين. هذا الصراع لا يُقدَّم في شكل مواجهةٍ خارجية، بل يُنسج داخل النفس البشرية، في توترٍ بين الخوف والإيمان، بين الرغبة في البقاء والحاجة إلى التغيير. فـ(الظل) في الرواية ليس مجرد استعارة جمالية، بل هو رمزٌ للأنوثة المقهورة التي ظلت تعمل في الخفاء، ولذا فإن الملكات لا يُستدعين كرموزٍ سلطوية، بل كأشباحٍ منسية تعود لتطالب بحقها في الاعتراف.
تتميّز الكاتبة بقدرة لافتة على صياغة الرمز عبر التفاصيل اليومية؛ فالسوق، والشارع، والمقهى، والمنزل، والمركز الاجتماعي، كلها تتحوّل إلى مشاهد تأملية تمتحن العلاقة بين الداخل والخارج، بين العالم الواقعي والبعد الوجداني للشخصية. اللغة في هذه الفصول لا تنقل الحدث بقدر ما تخلق له وجودًا جديدًا، إذ تتعالق الجملة مع الإيقاع النفسي لتصبح أداة تفكير، لا مجرد وسيلة وصف. وهكذا يُصبح النص روايةً عن الكتابة نفسها، عن البحث في المعنى، عن مقاومة النسيان بالكلمة.
ولعلّ أبرز ما يميّز الفصل الأول أنّه يُعيد تعريف البطولة النسوية، فيجعلها تمرينًا على الصبر المعرفي لا على الصدام، وعلى البناء البطيء لا الانفجار اللحظي. فهاجر لا تقف في وجه ناصر، زوجها، بصخبٍ احتجاجي، بل بثقةٍ صامتة تُربك النظام بأكمله. وفي حوارها مع والدتها فاطمة، يتجلّى العمق الأيديولوجي للرواية، إذ تنتقل الخبرة من جيلٍ إلى آخر، لا كذاكرة نوستالجية بل كوعي متجدد. الأم ليست ظلًّا، بل جذرٌ يُغذّي الفكرة في صمت، والابنة ليست ثورةً ضد الماضي، بل استكمالٌ له بمعايير أكثر وعيًا وعدلاً.
إنّ الرواية منذ هذا الفصل تؤسس لمفهومٍ فلسفيّ حول الأنوثة بوصفها ذاكرة جماعية، لا كيانًا فرديًا؛ فكل امرأة في النص ـ من ريم التي تنسحب خوفًا، إلى الأم التي تصمد، إلى الفتاة الصغيرة التي تُبذر في النهاية كسؤالٍ جديد ـ تمثل حلقةً في سلسلة الوعي الإنساني المتحوّل. بهذا المعنى، يتحوّل السرد إلى سجلٍ للمحو والمقاومة معًا، ويغدو (ظل الملكات) مشروعًا أدبيًا لإعادة كتابة التاريخ من ضفة المغيَّبات.
ولأنّ الوعي لا يولد من فراغ، فقد حرصت الكاتبة على أن يكون الفعل الروائي فعل كشفٍ متدرجٍ للذاكرة، إذ تبدأ الرواية من العتبة الرمزية للوحة المحروقة التي تخفي وجوه النساء القائدات، لتنتقل في الفصل الأول إلى فعل المواجهة الواقعية التي تعيد الحياة إلى تلك اللوحة. إنّ النار التي أحرقت التاريخ، بحسب الرمز الافتتاحي، هي ذاتها التي تُشعل الحاضر، لكن هذه المرة في يد امرأة لا تخشى الضوء. وهكذا تتحوّل الكتابة نفسها إلى إعادة ترميمٍ للوجوه التي أُخفيت، وإلى محاولة فلسفية لاستعادة الذاكرة بوصفها شرط الوجود.
يُمكن القول إنّ الفصل الأول من “ظل الملكات” هو قلب الرواية النابض، إذ يجمع بين الميلاد الفني والميلاد الفكري، وبين التجربة الفردية والموقف الجمعي، ويعلن منذ بدايته أن الصراع الحقيقي ليس بين المرأة والرجل، بل بين المعرفة والجهل، بين الوعي والسلطة، بين النسيان والكتابة. في هذا التقاطع بين الفكرة والتجربة، تنجح الرواية في تحويل الذات الأنثوية إلى مرآةٍ للمجتمع بأسره، وتفتح سؤالًا وجوديًا عميقًا: هل يمكن للذاكرة أن تُشفى من تاريخٍ كتبها على الهامش؟
تأتي هذه الدراسة لتفكك هذا السؤال عبر أربعة محاور رئيسة، تسعى إلى تتبّع البنية الجمالية والفكرية للنص، ورصد اشتغالاته الرمزية والنفسية، وتحليل كيف استطاعت الكاتبة أن تجعل من “الظلّ” مساحةً للانبعاث، ومن “الملكات” لغةً للوعي الجديد. فالرواية ليست مجرد صوتٍ نسوي، بل هي صوت إنسانيّ يواجه القهر بالمعنى، والغياب بالحضور، والظلام بالفكر.
المحور الأول: الوعي بالذات والعبور من الهامش إلى المتن
يبدأ الوعي في رواية “ظل الملكات” من لحظة بسيطة ظاهريًا، لكنها تأسيسية على مستوى الرمز: امرأة تسير في طريق رماديّ عند الصباح، محاطة بفوضى المدينة وضجيجها، لكنها تحمل في يدها حقيبة صغيرة مليئة بالأوراق. لا شيء في هذا المشهد يوحي بالبطولة أو الحدث الجلل، ومع ذلك، فيه تتشكّل النواة الأولى لفكرة الرواية بأكملها. فالفعل السردي الأول ليس حركة في المكان، بل ولادة في الوعي.
هاجر لا تمشي في الطريق وحسب؛ إنها تمشي خارجةً من منطقة الصمت الجمعي، من الهامش الذي وُضعت فيه النساء بوصفهن كائنات مكمّلة لا فاعلة. تلك الحقيبة التي تفيض بالأوراق ليست وثائق مشروعٍ اجتماعي فحسب، بل هي مجازٌ عن الذاكرة المغيّبة، عن أوراق التاريخ التي لم يُكتب فيها اسم امرأة إلا عرضًا أو صدفة.
منذ هذه اللحظة الأولى، يُعلن النص أن المعركة ليست سياسية أو ميدانية، بل معركة ضد النسيان. فكلّ عثرة في طريق هاجر ـ ازدحام السيارات، ازدحام السوق، سقوط الأوراق، اصطدام الطفل ـ هي اختبار رمزيّ لثبات الفكرة في وجه العشوائية والعطب الجمعي. تقاوم البطلة تلك العثرات الصغيرة بإصرارٍ داخلي لا يحتاج إلى شعارات، كأنها تقول إنّ التغيير الحقيقي يبدأ حين تتحوّل التفاصيل اليومية إلى فعل وعي.
وفي نهاية هذا المقطع، حين تضع يدها على باب مركز النور للتنمية الاجتماعية، يتحول الباب ذاته إلى عتبة عبور من الداخل المنكفئ إلى الخارج الفاعل، من الظل إلى الضوء، من الشك إلى الفعل. فـ(النور) ليس اسم المركز وحسب، بل هو إشارة رمزية إلى لحظة انبثاق الوعي من رحم التهميش.
الكاتبة توظّف في هذا الفصل أسلوبًا لغويًا يعتمد على الانسياب النفسي والتوتر الصامت. اللغة هنا ليست وصفًا للحدث بل انعكاسٌ لذبذبة الشعور الإنساني، فكل جملة تحمل انفعالًا داخليًا أكثر مما تصف مشهدًا خارجيًا.
إنّ هاجر لا تُقدَّم كبطلة جاهزة، بل ككائن يتكوّن ببطء أمام القارئ، يتحرك بين الخوف والرغبة، بين الإيمان والخذلان، بين الأنوثة والوعي.
وحين تقف أمام النساء في أول اجتماعٍ داخل المركز، تتحدث بعبارات تبدو بسيطة لكنها مشحونة بعمق رمزيّ لتقول : نحن لسنا هنا لنحلم فقط… نحن هنا لنبدأ.
هذه الجملة القصيرة تُمثل لحظة تفكيكٍ للخطاب الذكوري السائد؛ فهي تنقل المرأة من موقع الحلم السلبي إلى موقع الفعل البنّاء، من الانفعال إلى المبادرة. في تلك اللحظة بالذات، تتحوّل الغرفة الصغيرة التي تجمع النساء إلى مساحة بديلة للتاريخ، تاريخ يكتبه الوعي الأنثوي من جديد.
وهكذا تتجسد فكرة الاستنبات الفكري في العنوان الفرعي للفصل، حيث لا تنبت الفكرة في تربة السلطة، بل في أرضٍ هامشية، تُروى بالشكّ والإصرار معًا.
تتجلّى لحظة التحوّل الحقيقية عندما تواجه هاجر أول اعتراض من امرأة خمسينية تقول لها: الكثيرون جاؤوا قبلِك يا هاجر… وحكوا كلامًا حلوًا.
في هذا الحوار القصير يتكثف جوهر الصراع بين جيلين: جيل التجربة الذي آمن ثم انكسر، وجيل الإيمان الجديد الذي يحاول إعادة البناء. ردّ هاجر هنا لا يأتي بلغة الثورة، بل بلغة التصميم الهادئ: سنصنعها… لأننا هذه المرة لن نطالب بالفرص.
تغدو الجملة فعلًا فلسفيًا أكثر من كونها شعارًا؛ إذ تُعبّر عن انتقال المرأة من موقع التوسّل إلى موقع الفعل، من انتظار العدالة إلى صناعتها.
إنّ وعي البطلة لا يتأسس على رفض الآخر، بل على تجاوز حدود التبعية الذهنية. فهاجر لا تعادي الرجل كجنس، بل تعادي السلطة بوصفها منظومة فكرية تنتج الخضوع.
هنا تُعيد الكاتبة تعريف النسوية بعيدًا عن شعارات الصراع، لتجعلها نزعة تحرر إنساني تنطلق من الداخل قبل أن تواجه الخارج.
يتصاعد هذا الوعي الداخلي في المشهد الليلي الذي تقضيه البطلة مع أوراقها في غرفة مضاءة بمصباح خافت. هذا المشهد من أجمل ما في الرواية لأنه يختزل فلسفة الصراع بين الذات والفكرة.
هاجر أمام الأوراق تشبه راهبة أمام نصّ مقدس؛ تكتب وتشكّ، تؤمن وتخاف، لكنها لا تتوقف.
إنها صورة الإنسان حين يواجه ذاته قبل أن يواجه العالم، لحظة الإدراك أن المعركة ليست حول من يؤمن بك، بل حول مدى إيمانك بنفسك.
الكاتبة هنا لا تصف مشاعر هاجر بل ترسم حركتها الفكرية: إنها تُعيد كتابة جملها القديمة بخطّ جديد، وكأنها تعيد كتابة ذاتها.
حين تكتب بخطٍ حاسم “لن أتراجع، حتى وإن مشيت وحدي”، تتحول الكتابة إلى فعل وجوديّ يوازي فعل الثورة. فالكلمة ليست وسيلة تعبير، بل سلاح لإعادة صياغة الذات والواقع معًا.
في مقابل هذا الوعي الوليد، يظهر ناصر بوصفه تمثيلًا رمزيًا للمنظومة الذكورية التقليدية؛ لا لأنه شرير، بل لأنه أسير النظام الثقافي الذي كوّنه.
حواره مع هاجر ليس صراعًا بين زوجين، بل بين نموذجين من الوعي:
هو يمثل النظام الأبوي الذي يعتقد أن حماية المرأة تكون في تقييدها، وهي تمثل الذات الحرة التي تدرك أن الحماية الحقيقية في الوعي.
حين يقول لها ساخرًا: هل تعتقدين أن هذا ممكن فعلًا؟
تجيبه بثقةٍ هادئة: أنا لا أحاول، أنا أعمل.
بهذه الجملة الصغيرة، تسقط حجج السلطة الناعمة، ويُستبدل فعل المحاولة بفعل العمل. إنّها نقلة معرفية، لا لغوية فقط.
يتبدّى في هذا الحوار ما يمكن تسميته بـ تفكيك اللغة السلطوية، إذ تُعيد المرأة تعريف المفردات التي طالما استخدمها المجتمع لتثبيتها في موقع الضعف.
تتعمّق دلالة الوعي الذاتي حين تتدخل الأم، فاطمة، في المشهد الأسري المتوتّر.
صوتها الهادئ يكسر الصمت لا بالصراخ، بل بالحكمة، فتقول لناصر: «أنت غاضب، لأن ليس هاجر تجاوزت الحدود، بل لأنها رسمت طريقًا لم تُفكّر به أنت يومًا.»
هذا الصوت الأمومي ليس دفاعًا عن الابنة فقط، بل استدعاءٌ لتاريخٍ صامت من النضال الأنثوي.
فالأم، التي واجهت بدورها قهر الأزمنة السابقة، تمثل جذر الوعي النسوي الممتد عبر الأجيال، بينما تمثل الابنة ثمرته الجديدة.
هكذا تتحول العلاقة بينهما من علاقة رحمٍ بيولوجي إلى علاقة وراثة فكرية، تتناقل فيها النساء الوعي كما تُورّث العائلة أسماءها.
إنّ حضور الأم في الرواية ليس حضورًا ثانويًا؛ إنها الذاكرة الحية التي تُعيد للبطلة توازنها في كل لحظة شكّ، وتجعل من «الخوف» علامة وعي لا علامة ضعف.
وحين تنسحب ريم من المجموعة خوفًا على أسرتها، تواجه هاجر الحقيقة المرة: أن الثورة الفكرية لا تُخاض بالجماعات فقط، بل بالوحدة أيضًا.
تقول ريم: أنا حلمي هو الخطر كان، وهي جملة تختصر المأساة الاجتماعية؛ فالخطر ليس في الظلم، بل في الحلم ذاته.
أما هاجر فتجيبها بعبارة تلخّص روح الرواية: لا أحد يُلام على الخوف، لكن لا تنسي أن الخوف لا يوقفنا، بل يذكّرنا لماذا بدأنا.
هنا تبلغ الكاتبة ذروة الوعي الفلسفي؛ فالخوف يتحول من عائق إلى دافع، من انكماش إلى طاقة مقاومة.
وهكذا تتخذ الرواية من لحظة الانسحاب الفردي منطلقًا لتأكيد الاستمرارية الرمزية: امرأة ترحل، لكن الفكرة تبقى.
الميدالية الصغيرة التي تتركها ريم على المكتب تصبح أثرًا ماديًا لذاكرةٍ جماعية، علامةً على أن المشروع أكبر من الأفراد، وأن الهزيمة الجزئية لا تمحو الحلم الكلي.
في المشاهد الختامية من الفصل الأول، يتحول الشك إلى يقينٍ عبر استحضار الذاكرة الأمومية. فالأم تُعيد قراءة الدفتر القديم وتذكر ابنتها بجملتها الأولى التي كتبتها في طفولتها:الخوف لا يوقفني، بل يذكرني لماذا بدأت.
بهذا التذكير الرمزي، تُستعاد لحظة الميلاد الأولى للوعي، وكأن الزمن يدور دورة كاملة ليجد المعنى نفسه في موضع جديد.
الكاتبة هنا تبني ما يمكن وصفه بـ الهندسة الدائرية للوعي:
يبدأ النص من الشكّ وينتهي بالإيمان، لكن الإيمان لا يُقدَّم كحقيقة نهائية، بل كقدرة على الاستمرار رغم الشكّ.
وهكذا يصبح الشكّ ذاته شرطًا للوعي، لا نقيضًا له.
الرمزية في نهاية الفصل الأول تتكثف في الرسالة المجهولة التي تتلقاها هاجر، وفي العبارة المرسومة على الجدار: نحن ظلّ الملكات.
هذه اللحظة تتجاوز الحدث السردي لتغدو ولادةً للأسطورة داخل النص.
إنّ الظل هنا لا يعني الغياب، بل الاستمرارية الخفية التي تتناقلها النساء عبر الأجيال.
فـالملكات اللواتي مُحيت وجوههن من اللوحة في التمهيد الرمزي، عدن الآن كصوتٍ غامض يعلن ولادته في الحاضر.
وهكذا يتحقق الانصهار بين الماضي والمستقبل، بين الذاكرة والنبض، بين الفعل الفردي والمصير الجمعي.
إنها لحظة عبورٍ مكتمل: من الهامش إلى المتن، من الصمت إلى الكلمة، من الظلّ إلى الضوء.
بذلك، يقدّم الفصل الأول من (ظل الملكات) تجربة فريدة في تشكيل الوعي النسوي من الداخل، بعيدًا عن الشعارات الجاهزة.
إنه نصّ عن الإنسان في بحثه عن صوته، عن المرأة التي ترفض أن تكون موضوعًا للحكاية، فتغدو كاتبة الحكاية ذاتها.
ومن هنا تبدأ الرواية مشروعها الأكبر: أن الوعي ليس قرارًا، بل مسارًا، وأن النور لا يُمنح، بل يُكتسب بخطوةٍ تليها أخرى، في طريقٍ رماديّ، نحو بدايةٍ لا تنتهي.
المحور الثاني: الرمز واللغة كأدوات لتفكيك السلطة وإعادة بناء الذاكرة
في عالم (ظلّ الملكات)، لا تُمارس السلطة عبر السلاح أو القوانين فقط، بل عبر اللغة ذاتها. فالنظام الأبوي الذي تُحاربه الرواية لا يظهر في صورة حاكمٍ متسلّط أو مؤسسةٍ بيروقراطية، بل يتجسد في الخطاب، في طريقة تسمية الأشياء، وفي شكل الحكاية التي تُروى. لذلك كان من الطبيعي أن تختار الكاتبة اللغة بوصفها ساحة الصراع الأولى، والرمز بوصفه سلاح الوعي المضاد.
إنّ تفكيك السلطة في الرواية يبدأ من تفكيك لغتها، إذ تعمد الكاتبة إلى تقويض كل المفردات التي أُنتجت لتبرير الخضوع، واستبدالها بمعجمٍ جديد قوامه الوعي، لا التبعية.
اللغة: من أداة خطاب إلى فضاء مقاومة
منذ السطر الأول في الفصل الأول، تشتغل اللغة على مستوى يتجاوز التواصل. فحين تقول الكاتبة إنّ الصباح كان «رماديّ المزاج»، فإنها لا تصف الطقس، بل تصف الوعي الجمعي الذي تعيشه الشخصيات. اللون الرماديّ هو لون الحيرة، اللايقين، المنطقة التي تتأرجح بين النور والظلام. بهذا اللون تُفتَح الرواية وتُؤسَّس دلاليًا، لأن الصراع الذي سيجري لاحقًا ليس بين أبيض وأسود، بل في المساحات الرمادية للضمير الإنساني، حيث تختبر المرأة إمكانية النطق في فضاءٍ مُبرمج على الصمت.
تتحدث هاجر بصوتٍ يبدو خافتًا في ظاهره، لكنه مشحون بطاقة رمزية. حين تقول: نحن لسنا هنا لنحلم فقط… نحن هنا لنبدأ،
فهي لا تنطق جملة تحفيزية، بل تُعلن ولادة لغة جديدة. في الخطاب الذكوري السائد، يُختزل الفعل النسوي في الحلم، بينما الفعل السياسي والمجتمعي محفوظ للرجل. هنا تُعيد الكاتبة ترتيب المعادلة: الحلم ليس غاية، بل مقدمة للفعل؛ والبدء ليس امتيازًا، بل حقّ.
إنّ الجملة البسيطة تتحول إلى إعلان لغويّ للسيادة، لأن من يحق له أن يعلن البداية يحق له أن يكتب التاريخ.
الرمز كاستعارة وجودية
لا تتعامل الرواية مع الرمزية كزخرف فني، بل كأداة إبستمولوجية تكشف ما خفي في طبقات المعنى.
فكلّ تفصيل في النص يحمل ظلّه الرمزي:الحقيبة المليئة بالأوراق هي ذاكرة نسوية تسعى إلى التوثيق.
السوق الشعبيّ المزدحم هو صورة المجتمع الذي يبتلع الأصوات الفردية.
الطريق الرماديّ الطويل هو المجاز الممتد للرحلة الوجودية نحو الوعي.المركز الاجتماعيّ (النور) هو استعارة للمعرفة، التي تبدأ من غرفة صغيرة وتكبر لتغدو فضاءً تحرريًا.
بهذا المعنى، يتحوّل العالم الواقعي في الرواية إلى مسرحٍ رمزيّ للذاكرة الأنثوية، حيث كلّ مشهد يلمع كمرآة عاكسة لما تمّ محوه.
فعندما تسقط أوراق هاجر في الشارع وتلتقطها واحدة تلو الأخرى، لا نقرأ حدثًا عرضيًا بل نرى رمزًا لاستعادة التاريخ المبعثر. إنّها تُلملم صفحات ماضيها المسروق كما تُلملم أوراق مشروعها الاجتماعي.
تفكيك الذاكرة الذكورية
الكاتبة تدرك أن التاريخ نفسه قد صيغ بلسانٍ واحد، وأنّ ذاكرة الأمم هي نتاج القلم الذي كتبه المنتصرون، لا صوت الذين صمتوا قهرًا. لذلك تضعنا الرواية منذ بدايتها أمام مهمة مزدوجة: أن نقرأ التاريخ لا كما كُتب، بل كما أُخفي.
هاجر لا تقرأ الأرشيفات في المؤسسات الرسمية فقط، بل تُعيد تأويل كلّ ما حُجب عن الوعي العام.
وحين تواجه الموظفة البيروقراطية في الأرشيف الوطني لاحقًا، نكتشف أن اللغة الإدارية ذاتها هي أداة قمعٍ ناعمة؛ إذ تُخفي الحقيقة خلف مصطلحات مثل السجلات المغلقة والموافقات الوزارية، وهي كلمات تبدو حيادية لكنها تُمارس فعل المنع والإقصاء.
هكذا تتحوّل اللغة الرسمية إلى سلطة ميتافيزيقية، تحرس النسيان باسم النظام، وتحجب المعرفة باسم الأمانة.
ومن هنا، تبدأ وظيفة الكاتبة في تحويل اللغة إلى أداة كشفٍ مقاومة.
حين تصرّ هاجر على البحث عن وثائق النساء، فإنها لا تواجه مؤسسة بيروقراطية فحسب، بل تواجه نظامًا معرفيًا بُني على مبدأ أن المرأة لا تملك ذاكرة تستحق الأرشفة.
إنها تُعيد كتابة التاريخ لا بإضافة أحداثٍ جديدة، بل بإعادة النظر في معنى الكلمة ذاتها: ماذا يعني أن تكون هناك «ملكة»؟ ماذا يعني أن يُقال «ظلّ»؟
فالظلّ في المعنى المألوف تابعٌ، لكن في الرواية يصبح هو الحضور البديل، الوجه الذي لا يُمكن حرقه حتى حين تُحرق اللوحة.
المجاز المركزي: من اللوحة المحروقة إلى الجدار
من أجمل الرموز في الرواية مشهدان يلتقيان عبر مسافة زمنية طويلة:
الأول في التمهيد الرمزي حين تُشاهد الفتاة اللوحة المحروقة لنساءٍ مجهولات،
والثاني في نهاية الفصل الأول حين تُكتب على الجدار عبارة (نحن ظلّ الملكات).
المشهدان يشكلان قوسًا رمزيًا يُغلق على المعنى الكامن في النص:
اللوحة الأولى تحترق لأن السلطة أرادت محو الوجوه، والجدار الأخير يُعيد رسم الظلال التي لا تُمحى.
بين الحرق والكتابة يتحقق فعل المقاومة؛ فالكتابة هي الحريق المعاكس، نار الوعي التي تُنضج الذاكرة بدل أن تفنيها.
في اللحظة التي تقرأ فيها هاجر الرسالة المجهولة وتراها ممهورة بالعبارة ذاتها، نعلم أن اللغة قد استعادت قوتها الأولى: لم تعد أداة قمع، بل طاقة بعث.
تلك العبارة القصيرة (نحن ظل الملكات) تتجاوز معناها الحرفي لتصبح مانيفستو فكريًا، إعلانًا عن ميلاد جماعة من الوعي الأنثوي العابر للأزمنة.
فالضمير الجمعي (نحن) يذيب الفردية ويحوّل الذات إلى جزء من سلالة فكرية غير مرئية.
والظلّ، الذي كان يُفهم سابقًا كغيابٍ عن الضوء، يُقدَّم هنا كاستمرارية له، كامتدادٍ يذكّر بما لم يُرَ، لكنه وُجد.
الصوت كإعادة تعريف للكينونة
من المثير أن هاجر لا تصرخ في وجه أحد، ولا ترفع صوتها احتجاجًا. فالكاتبة ترفض الصوت العالي بوصفه سلوكًا ذكوريًا في التعبير عن القوة.
بدل ذلك، تجعل من الصمت أداة تفكير، ومن الصوت الداخلي شكلاً من أشكال المقاومة الهادئة.
في المشاهد الليلية التي تحاور فيها هاجر نفسها، تتحول اللغة إلى مرآة داخلية تكشف عمقها النفسي.
وحين تتحدث مع أمها، يكون الحوار أقرب إلى طقسٍ معرفيّ، تُمرر فيه الحكمة لا كتعليمٍ مباشر، بل كتوريثٍ رمزيّ لتجربة الصبر والمعنى.
إنّ الرواية تُقدّم نموذجًا للأنثى المفكّرة، لا بوصفها تكرارًا للرجل العاقل، بل بوصفها صاحبة وعيٍ مختلف في بنيته وفي لغته.وعي لا يُلغي العاطفة، بل يُعيد تعريفها كمصدر للبصيرة.فحين تقول الأم لابنتها: كل قائد مر بلحظة شكّ، لكن الفارق أن البعض يكمل رغم الشك، فهي لا تبرر الضعف بل تحوّله إلى طاقة روحية. بهذه البساطة، تنقلب مقولة الخوف من نقيضٍ للفعل إلى شرطٍ لوجوده.
تفكيك الذكورة بوصفها خطابًا لغويًا
تتعامل الكاتبة مع الذكورية لا كجنسٍ بيولوجي، بل كـ بنية لغوية وفكرية. فناصر، زوج هاجر، لا يُقدَّم كعدوّ، بل كصدى لخطابٍ اجتماعيّ تشرّب مفاهيمه حتى صارت جزءًا من وعيه.
هو لا يدافع عن نفسه بقدر ما يكرر عبارات المجتمع التي حفظها عن ظهر قلب: هل تعتقدين أن هذا ممكن؟… الناس لن يتقبلوا… المجتمع لا يسمح.
إنه يتحدث بلغةٍ مبرمجة، لغةٍ لا تملك أصالتها، ولهذا السبب تفشل سلطته أمام صمت هاجر، لأن الوعي لا يُهزم إلا بلغةٍ أصدق منه.
الكاتبة لا تهاجم الرجل بوصفه فردًا، بل تكشف خواء الخطاب الذكوري حين يُجرَّد من المعنى.
وعندما ترد هاجر قائلةً:” أنا لا أحاول، أنا أعمل” ، فهي لا تهاجم ناصر، بل تفكك منطقه اللغوي: فعل (يحاول) يحيل إلى الشكّ في الإمكان، بينما «يعمل» يحيل إلى الإيمان بالفعل.وبين الفعلين مسافة الوعي كله.
الشكل اللغوي بوصفه مرايا المعنى
النصّ في (ظل الملكات) يعتمد على لغةٍ عالية الشفافية، تُوازن بين الشعرية والاقتصاد في التعبير.الجملة لا تتدفق بانفعالٍ عاطفي بل بتأملٍ منطقي، وكأنها تُنحت نحتًا من داخل التجربة.
لا وجود لعباراتٍ استعراضية أو توصيفٍ مجانيّ؛ فكلّ جملة تُؤدي وظيفة فكرية قبل أن تُرضي الأذن الجمالية.
بهذه السمة، تصبح اللغة في الرواية لغة تفكيرٍ لا تزويق، أي أنها لا تصف الحدث بل تخلقه.
حين تكتب د.ميسون عن هاجر وهي تنظر من النافذة في الفجر قائلة: (كل فجر لا يولد من الضوء، بل من قرار)،تتحول الجملة إلى قانون وجوديّ.
الفجر هنا ليس ظاهرة كونية بل فعل إرادي، والقرار هو النور الذي يتجاوز الفيزياء إلى الفلسفة.
تلك الجمل القصيرة الكثيفة هي التي تمنح النص عمقه، وتجعل من الرواية تجربة تأملية تتجاوز حدودها الحكائية.
فالقارئ لا يخرج من الرواية وفي ذهنه حبكة متتابعة، بل منظومة من المعاني التي تحرض على التفكير.
اللغة كاستعادة للذاكرة الجماعية
يستند النص إلى ذاكرة نسوية ممتدة، تبدأ من الأم فاطمة وتمتد إلى الابنة، ثم إلى الطفلة الصغيرة في التمهيد الرمزي.
هذه السلسلة من الأصوات تخلق سيمفونية لغوية واحدة؛ فكلّ جيل يضيف نغمة جديدة إلى الأغنية القديمة ذاتها:أغنية البقاء.
إنّ انتقال العبارة من الأم إلى الابنة (الخوف لا يوقفني، بل يذكرني لماذا بدأت) يُمثّل لحظة استعادة للذاكرة الجمعية من خلال اللغة. فالكلمة نفسها تُعاد بعد سنوات، لكنها تكتسب معنى جديدًا؛ ما كان وعدًا في الماضي صار تجربة في الحاضر.
بهذا الشكل، تتحوّل اللغة إلى وعاءٍ للزمن، تحمل الذاكرة عبر الأجيال دون أن تفقد حرارتها الأولى.
وهكذا تبرهن الكاتبة أن اللغة ليست وسيلة تواصل بين شخصين، بل بين زمنين، بين ما كان وما سيكون.
الرمز بوصفه ذاكرة متجددة
كل رمز في الرواية يحتفظ بحيويته لأنه لا يُقدَّم كإشارة مغلقة، بل كحركة دلالية مفتوحة.
الظلّ، مثلاً، ليس ثابتًا؛ فهو يتغيّر تبعًا لمصدر الضوء، أي تبعًا لوعي الشخصيات.
في البداية، يمثل الظلّ الخضوع والصمت، لكنه يتحوّل في النهاية إلى حضورٍ موازٍ للضوء، حضورٍ لا يمكن إلغاؤه.بهذا، يُعيد النص تعريف المفهوم نفسه:الظلّ لم يعد عتمة، بل دليلًا على وجود الضوء.
وهذه المفارقة الدلالية هي ما يمنح الرواية عمقها الفلسفي؛ إذ تنقلب المفاهيم المألوفة على أصولها، وتُبعث اللغة في شكلٍ جديد من المعنى.
الكتابة كفعل تحرّر
في نهاية الفصل الأول، حين تمسك هاجر بالقلم لتكتب في دفترها، لا تكتب تقريرًا أو مشروعًا إداريًا، بل تكتب ذاتها.
إنها تمارس الكتابة بوصفها مقاومة؛ فكل حرفٍ تكتبه هو خطوة في طريق التحرّر، وكل جملةٍ تصوغها تُعيد من خلالها ترتيب العالم.
تُصبح الكتابة هنا بديلاً عن الفعل الثوريّ الخارجي، إذ تحوّل المعاناة إلى وعي، واليأس إلى طاقة.ولذلك، حين تصل الرسالة المجهولة التي تقول (ليس كل ظلّ يحمل حنينًا)، نجد أن البطلة لا ترتبك بل تبتسم، لأن اللغة التي كانت سلاح السلطة صارت الآن سلاحها هي.
لقد استعادت الكلمة من قبضة القاموس الرسميّ، وأعادت إليها نبض الإنسان.
بهذا المعنى، يمكن القول إن (ظل الملكات) ليست رواية عن النساء فقط، بل عن اللغة نفسها؛ عن الكلمة التي كانت قيدًا وصارت خلاصًا، عن الرمز الذي كان ستارًا وصار مرآة.
إنّ الكاتبة تُمارس فعلاً مزدوجًا: تفكيك خطاب السلطة وإعادة كتابة الذاكرة.
تفكّك الخطاب لأنها تدرك أن كل سلطة تبدأ من الكلمة، وتعيد كتابة الذاكرة لأنها تعرف أن التاريخ لا يُستعاد إلا بالحبر.
هكذا تُغدو الرواية درسًا في أنسنة اللغة، إذ تُعيد إليها وظيفتها الأصلية: أن تكون بيت المعنى، لا زنزانته.
وفي هذا البيت الجديد، تجلس الملكات اللواتي طُمست وجوههن، لا كظلالٍ خافتة، بل كأرواحٍ تكتب على الجدار بلغةٍ لا تُمحى: نحن ظلّ الملكات.
المحور الثالث: تحولات الوعي الجماعي وصراع الذاكرة مع السلطة
تتحرك رواية ظلّ الملكات من الخاص إلى العام، من التجربة الفردية إلى الوعي الجمعي، لتكشف أن مأساة هاجر ليست مأساة امرأة واحدة، بل تجسيد رمزيّ لضميرٍ جماعيّ نسائيّ ظلّ مقموعًا ومهمّشًا لقرون. فالرواية، وإن انطلقت من حكاية امرأة محددة، إلا أنها تُعيد ترتيب العلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الذاكرة الشخصية والتاريخ العام. إنّها لا تروي سيرة، بل تكتب تحوّل الوعي من الهامش إلى المجال العام، حيث يصبح الفعل الفردي بذرة لانبعاث جماعيّ.
من الوعي الفردي إلى الوعي الجمعي
يبدأ النص من عزلة البطلة، من ذلك الشعور العميق بالانفصال عن العالم، لكنه لا يبقى هناك.
تتحول العزلة إلى تفكير، والتفكير إلى مشروع، والمشروع إلى حركة. وهكذا يُعاد إنتاج الفعل الاجتماعي من الداخل إلى الخارج.
هاجر ليست متمرّدة بالمعنى التقليدي، بل مُنشئة وعي؛ إنها تعرف أن التمرد الصاخب سريع الزوال، أما البناء الصامت فيرسخ في الأعماق.
من خلال مركز (النور للتنمية الاجتماعية)، تخلق الكاتبة مساحةً رمزية لتشكّل الوعي الجمعي النسائي. فالاجتماعات البسيطة، والنقاشات الصغيرة حول التعليم والعمل والحقوق، تتحول إلى مختبر للحرية، حيث تُبنى اللغة المشتركة ويتكوّن المعجم الجماعي الجديد.
تتحول تلك الغرفة إلى ما يمكن وصفه بـ (مختبر الذاكرة)؛ إذ يُعاد فيه تعريف الماضي لا كعبءٍ ثقيل، بل كذاكرة يمكن أن تُستعاد لإضاءة الطريق.
الوعي الجمعي في الرواية ليس تجمّعًا رقميًا أو عددًا من النساء يتشاركن الفكرة، بل هو حالة شعورية فكرية تنشأ حين تلتقي التجارب الفردية في نقطة إدراكٍ مشتركة: أن الصمت لم يعد خلاصًا، وأن الخوف لم يعد قدرًا.
حين تقول إحدى النساء في الاجتماع: كلنا خائفات، لكن من قال إن الخوف لا يصنع شجاعة؟،فإنها لا تعبّر عن رأي شخصي بل تُعبّر عن لحظة انتقال معرفي في الوعي الجماعي؛ فالخوف هنا لم يعد نقيضًا للشجاعة، بل صار أصلها.
بهذه اللغة، تضع الكاتبة الأساس لفهمٍ جديد للبطولة النسوية: البطولة ليست في القتال أو الصراخ، بل في الاستمرار رغم التهديد.
تلك الشجاعة اليومية التي تمارسها النساء في تفاصيل الحياة — الذهاب إلى العمل، مواجهة العائلة، التمسك بالتعليم — هي جوهر الفعل المقاوم الذي تبني عليه الرواية فلسفتها.
الذاكرة بوصفها ميدان الصراع
في عمق الرواية، تدور معركة كبرى غير معلنة: صراع على الذاكرة.فالسلطة — سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية — لا تخشى فعل التمرد، بل تخشى فعل التذكّر. لأن من يتذكّر يمتلك سرديته، ومن يملك السردية يملك الحقيقة.
لذلك تسعى الأنظمة الذكورية إلى احتكار الذاكرة عبر التعليم والإعلام والتاريخ الرسمي. في المقابل، تحاول النساء في «ظلّ الملكات» إعادة كتابة هذه الذاكرة من منظورهن، لا بنقض التاريخ، بل بإضافة الصوت المغيّب الذي كان دائمًا في الهامش.
حين تُصرّ هاجر على جمع شهادات النساء المسنّات، لا تفعل ذلك كمهمة اجتماعية، بل كفعل استعادةٍ روحيّ. فكل شهادة هي ذاكرة مصادرة تُستعاد من الصمت إلى العلن.
وفي مشهدٍ بالغ الرمزية، عندما تفتح إحدى الجدّات صندوقها القديم وتُخرج وشاحًا باهت اللون وتقول: (هذا ليس وشاحًا، بل حكاية لم يسمعها أحد)،
تفهم هاجر أن الأشياء — حتى المادية منها — هي حوامل للذاكرة.
إنّ الرواية هنا تُمارس وظيفة أنثروبولوجية سردية، إذ تكشف كيف يمكن للموروث الشعبي البسيط أن يكون ذاكرةً مقاومة، وكيف أن الحكاية الشفهية التي حفظتها النساء عبر الأجيال هي في جوهرها شكل من أشكال كتابة التاريخ البديل.
السلطة كآلية لمحو الذاكرة
في مقابل هذا الجهد النسوي لاستعادة الذاكرة، تقف سلطة تمارس فعل الحذف بطرائق مختلفة:
مرةً عبر السخرية، ومرةً عبر التجاهل، ومرةً عبر التشويه.
حين تحاول إحدى الصحف الرسمية أن تكتب تقريرًا عن مركز «النور»، تكتفي بوصفه بأنه «نشاط اجتماعي خيري»، متجاهلةً البعد الفكري التحرّري الذي يحمله.
هذا التقزيم اللغوي أحد أبرز أسلحة السلطة في محو الذاكرة؛ فهي لا تحظر الفكرة، بل تُفرغها من معناها.
وحين تحاول إحدى النساء كتابة مقالٍ عن المشروع، تُرفض المقالة بحجة أنها غير مناسبة للذوق العام.
تُعيد الرواية هنا إنتاج ما سمّاه ميشيل فوكو بـرقابة الخطاب — السلطة التي لا تمنع القول فحسب، بل تحدد ما يُقال وكيف يُقال.
تُمارس الكاتبة نقدًا عميقًا لهذه الآلية حين تُظهر كيف يتحوّل التواطؤ المجتمعي إلى شريكٍ للسلطة، وكيف يُصبح الخضوع عادة يومية تلبس ثوب الأدب والاحترام.
التحوّل النفسي للوعي الجماعي
مع تطوّر الأحداث، تتبدّل لغة النساء ونبرة الحوار. فبينما كانت الجمل في البداية مترددة ومكسورة، تميل إلى الاستفهام، تتحول تدريجيًا إلى لغة تقريرية واثقة.
تقول ريم في أحد الاجتماعات الأخيرة: لم نعد نسأل إن كان لنا حق، بل كيف نمارسه.
بهذه الجملة تنقلب بنية الوعي الجماعي رأسًا على عقب؛ فالسؤال لم يعد عن الشرعية، بل عن الآلية.
لقد تجاوزت النساء مرحلة الدفاع إلى مرحلة الفعل، وانتقلن من موقع الضحية إلى موقع الفاعل.
هذا التحول النفسي لا يتم دفعة واحدة، بل عبر تراكمٍ دقيق من التجارب: مواجهة الخذلان الأسري، الصدام مع السلطة، الانقسام الداخلي بين الإيمان والخوف.
ولذلك تبدو الرواية أقرب إلى رحلة وعي جماعي منها إلى رواية أحداث؛ فالبناء السردي يتبع إيقاع التحوّل النفسي لا التتابع الزمني.
كل خطوة في وعي هاجر تُعيد تعريف ذاتها في وعي الأخريات، وكأنّ الوعي ينتقل بعدوى الصدق، لا بعدوى الفكرة فقط.
المقدّس والسيطرة الرمزية
من الجوانب اللافتة في الرواية حضور المقدّس كأداة سلطة رمزية. فالسلطة الذكورية لا تعتمد فقط على القانون أو العرف، بل على الشرعية الأخلاقية التي تستمدها من تأويل النصوص الدينية أو التقاليد.
لكن الكاتبة تتعامل مع هذا البعد بحذرٍ فكريّ راقٍ؛ فهي لا تهاجم الدين، بل تكشف الفرق بين الإيمان الصادق والتأويل السلطوي له.
في أحد الحوارات، تقول هاجر لامرأة مترددة: الله لم يخلقنا لنسكت، بل لنشهد بالحق، والصمت ليس شهادة.
بهذه الجملة تُعيد تعريف العلاقة بين الإيمان والفعل. تُحرّر النصّ الديني من سلطة التأويل الذكوري، وتعيد إليه جوهره الإنساني القائم على العدالة والمساواة.
بهذا الشكل، تتحول الرواية إلى نصّ مضادّ للقداسة الزائفة، إذ تفكك كيف يتحول المقدّس إلى أداة قمع حين يُحتكر تفسيره.
وتُقدّم بديلًا فلسفيًا يقوم على أن المقدّس الحقيقي هو الكرامة الإنسانية ذاتها، وأنّ كل سلطة تنتهك الكرامة تُفقد شرعيتها مهما كانت لافتتها.
الذاكرة الجمعية كفعل شفاء
الذاكرة في الرواية ليست مجرد استعادةٍ للماضي، بل هي فعل شفاء من الجرح الجمعي.فالنساء لا يتذكّرن ليتألمن، بل ليتحررن.
كل حكاية تُروى داخل المجموعة تحمل في طياتها ألمًا، لكن أيضًا طاقة استعادة.
في مشهدٍ عميق الدلالة، حين تبكي إحدى النساء وهي تروي كيف فقدت عملها بسبب تحرش المدير، لا تواسيها هاجر بالشفقة، بل تقول: العار ليس في الحكاية، بل في السكوت عنها.
بهذا القول، تتحول الحكاية إلى علاجٍ نفسيّ، والذاكرة إلى معبرٍ من الألم نحو الوعي.
إنّ الكاتبة هنا تستلهم ما يسميه بول ريكور (الذاكرة السردية) — أي تحويل الجرح إلى معنى، وتحويل المعاناة إلى سردٍ يعيد للإنسان كرامته.
فمن خلال الحكاية، يُشفى الجرح لأنه يُصبح مفهومًا، لأن المعنى يحلّ محلّ الفوضى.
السلطة المضادة: ولادة الجماعة الجديدة
مع تصاعد الوعي الجمعي، تنشأ سلطة جديدة في الرواية — سلطة المعرفة.
لم تعد السلطة حكرًا على المؤسسات، بل باتت في يد النساء اللواتي يملكن سرديتهن الخاصة.
المعرفة هنا ليست تنظيرًا أكاديميًا، بل معرفة بالتجربة، بالوجع، بالحب، بالصبر.
وفي لحظة رمزية، حين تُعلّق النساء على جدار المركز عبارة «الوعي لا يُستأذن»، تُعلن الرواية ولادة شكل جديد من السلطة، سلطة لا تستعبد بل تحرر.
السلطة الجديدة لا تقمع، لأنها تستمد شرعيتها من الاعتراف لا من القهر. كل امرأة تعترف بحكايتها تمنح الأخريات شجاعة النطق، وهكذا تتوالد السلطة من الصدق، لا من الخوف.
تتحول المجموعة الصغيرة إلى مجتمع مصغّر، يمارس الديمقراطية المعرفية قبل أن يطالب بها سياسيًا.
إنه نموذج مصغّر لعالمٍ ممكن، حيث تتشكل العلاقات على أساس الوعي لا النوع، وعلى أساس الفهم لا الخضوع.
الكتابة كذاكرة مضادة
الرواية نفسها تُقدّم نموذجًا للكتابة بوصفها ذاكرة مضادة. فالكاتبة لا تكتب لتؤرخ للماضي، بل لتستعيد المسكوت عنه وتُعيد ترتيبه في الوعي المعاصر.
إنّ فعل الكتابة هنا ليس توثيقًا بل مقاومة، لأن كل نصٍّ جديد يُكتب خارج الخطاب الرسمي هو في ذاته فعل تمرد معرفي.
وإذا كانت السلطة قد أحكمت سيطرتها على وسائل السرد التقليدية — الإعلام، التعليم، التاريخ الرسمي — فإن الأدب يبقى المساحة الوحيدة القادرة على تجاوز الرقابة، لأنه يعمل في اللغة، واللغة أوسع من الجدار.
بهذا المعنى، (ظلّ الملكات) لا تروي حكاية ضد السلطة فقط، بل تكتب ضد نظام الكتابة السلطوي نفسه.
من الظلّ إلى النور: اكتمال التحول الجمعي
في نهاية الفصل، حين تتوزع النساء على الأحياء لإقامة ورش التعليم، نصل إلى لحظة رمزية مفصلية.
المركز الصغير الذي كان ملاذًا يتحول إلى منارة.لم تعد المجموعة تعمل في الظلّ، بل في النور.لكن المدهش أنهن لا يُنكرن الظلّ، بل يحتفين به. تقول هاجر في الاجتماع الأخير: الظلّ ليس نقيض النور، بل أثره. كل من يضيء يترك ظلًا.
بهذه الجملة تُغلق الدائرة الفكرية للرواية.
الظلّ، الذي كان رمزًا للتبعية، صار الآن دليل الوجود.
وهكذا يتحقق التحول الجمعي الكامل: من وعيٍ خائفٍ يسعى إلى الضوء، إلى وعيٍ ناضجٍ يحتضن ظله لأنه يعرف أنه جزء من المعنى.
إنّ رواية ظل الملكات لا تقدّم ثورة نسوية تقليدية، بل ثورة وعي تتجاوز النوع إلى الإنسان.
فالكاتبة تُعيد تعريف العلاقة بين السلطة والذاكرة واللغة والذات، لتؤكد أن الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، من تلك اللحظة التي يقول فيها الإنسان: أنا أتذكر، إذن أنا موجود.
وفي هذا الوعي بالذاكرة، تولد الحرية مشروعًا تأمليًا في الوعي والوجود والذاكرة.
إنّ رواية ظلّ الملكات لا تنتمي إلى السرد الواقعي البسيط الذي يكتفي بتسجيل التحولات الاجتماعية، بل تتجاوز ذلك إلى أفقٍ فكريّ يجعل من الجمال أداة تفكير، ومن الفن وسيلة لتفكيك الواقع وإعادة صياغته. فهي رواية تتكئ على جمالية الفكر لا على زخرف اللغة، وتستمد عمقها من تأملها في معنى الوجود الإنساني، لا من صخب الأحداث.
فيها تُصبح الحكاية قناعًا للفكرة، والشخصية وسيلة لتجسيد المفهوم، واللغة مختبرًا فلسفيًا يُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم.
ولذلك، لا يمكن قراءة ظلّ الملكات إلا بوصفها نصًا يستدعي الفلسفة عبر الجمال، ويُمارس الجمال بوصفه تفكيرًا في الوجود.
الجمال كطريق إلى الوعي
منذ الصفحات الأولى، تتجلّى فكرة أن الجمال في الرواية ليس زينة بل وعي متجسد.
الكاتبة لا تكتب عن العالم كما هو، بل كما ينبغي أن يُرى، كما لو أنها تريد تطهير الواقع من قبحه بالكتابة.
إنّ السوق المزدحم، الشوارع المتربة، الصمت القاسي — جميعها تُقدَّم بلغةٍ تخلّص القبح من بشاعته عبر الوصف الجمالي، لا لتجميله، بل لإدراك عمقه.
فالكتابة الجميلة هنا ليست هروبًا من الواقع، بل مواجهة له بمستوى أرفع من الإدراك.
وحين تصف الكاتبة ملامح وجه هاجر وهي تتأمل انعكاسها في زجاج النافذة، لا تقدّم صورةً حسّية، بل تجربة وعي تقول فيها البطلة: لم أرَ نفسي في الزجاج، بل رأيت ما تبقّى مني.
إنّ الجمال في هذه اللحظة ليس مرآة للزينة، بل أداة معرفة؛ فالرؤية الجمالية تُصبح شكلًا من أشكال التفكير في الذات.
الجمال إذن هو وسيلة الرواية لاستعادة ما سُلب من المرأة: حقّها في أن ترى العالم وتعيد تأويله.
فالسلطة لا تكتفي بحرمان المرأة من الفعل، بل من النظر أيضًا؛ لأن من يملك الرؤية يملك التفسير.
لهذا تتحول الكتابة إلى فعل بصريّ، إلى استعادة للبصر المسلوب، وكأنّ الكاتبة تقول: أن ترى الجمال، يعني أن تستعيد نفسك من القبح الاجتماعي.
الفكر بوصفه خلاصًا من العدم
في عمق الرواية يسكن سؤالٌ فلسفيّ جوهريّ: ما معنى أن تكون موجودًا؟
هاجر لا تبحث عن الحرية فقط، بل عن معنى وجودها داخل عالمٍ يصرّ على تعريفها من الخارج.
كلّ صمتٍ تواجهه، وكلّ قيدٍ يُفرض عليها، يتحول إلى مادة تفكير؛ لذلك تتخذ الرواية شكل تأملٍ وجوديّ في الحرية والضرورة.
حين تقول البطلة في إحدى لحظات الخذلان: أنا لست ضد العالم، لكني ضد أن أكون صدى له، فهي تُعبّر عن جوهر الفلسفة الوجودية: أن تكون الإنسان أصيلًا لا تابعًا، أن تكون فاعلًا لا صدى.
إنها تواجه العدم لا بالخوف بل بالوعي؛ فالعدمية في الرواية ليست غيابًا للمعنى، بل لحظة اختبارٍ لمعناه الأعمق.
ومن هذا المنظور، تتحول الرواية إلى رحلة داخل الذات البشرية في بحثها عن الأصالة، عن التوازن بين أن تكون في العالم وأن تبقى نفسك رغم العالم.
الحب بوصفه فعل وعي
على الرغم من أن الرواية مشغولة بالتحرّر الاجتماعي والسياسي، إلا أن الحب فيها يحتل مكانًا جوهريًا بوصفه اختبارًا للوعي لا للعاطفة.
فالعلاقة بين هاجر وناصر ليست علاقة حبٍ مأزومة فحسب، بل علاقة فكرين متناقضين يختبران معنى المشاركة الإنسانية.
ناصر يحب هاجر، لكنه لا يعرف كيف يحبّ امرأة تفكّر؛ إنه يحبها ضمن الإطار المألوف الذي يجعل الحب ملكية.
أما هي، فترى في الحب مساحة وعيٍ مشترك، لا عقدًا من التبعية.
ولذلك، حين تقول له في لحظة مواجهة:أحبّك، لكني لن أكون مرآتك.
تكون قد أعلنت عن أكثر أشكال الحبّ وعيًا: الحبّ الذي يرفض الذوبان في الآخر، ويختار اللقاء على قدم المساواة.
إنّ هذا النوع من الحبّ الفلسفي هو ما يجعل الرواية تتجاوز التناقض المألوف بين الذات والآخر، لتقدّم نموذجًا للعلاقة الإنسانية الناضجة، حيث المحبة فعل وعيٍ متبادل، لا علاقة قوة.
وهكذا يتحوّل الحب في الرواية إلى معادل فلسفي للحرية: كلاهما لا يعيش إلا حين يُمارَس بوعي.
الفلسفة الوجودية في البناء السردي
تُبنى الرواية وفق منطقٍ يذكّر بالقواعد الوجودية في الفكر الحديث:الذات في مواجهة العالم،الحرية في مواجهة الضرورة،الذاكرة في مواجهة النسيان،المعنى في مواجهة العدم.
كلّ مشهدٍ سرديّ هو تمرينٌ على هذا الصراع الداخلي.
في لحظةٍ من العزلة، تقول هاجر وهي تتأمل المدينة من نافذتها: كلّ هذه الأضواء تخاف من الظلام الذي فيها.
بهذه الجملة القصيرة، تختصر الكاتبة فكرة أن الضوء نفسه ليس نقيض العتمة بل ابنها، وأن الإنسان لا يكتمل إلا حين يواجه ظله الداخلي.
إنها فكرة مستمدة من عمق الفلسفة الوجودية كما صاغها كيركغارد وسارتر، لكنها تُعاد صياغتها في الرواية بلغةٍ أدبية رقيقة تذيب الفلسفة في الشعر.
الظلّ بوصفه استعارة وجودية
من الناحية الجمالية، يُمكن اعتبار الظل محورًا فلسفيًا للرواية.
الظلّ في الوعي المألوف علامة غياب، لكنه في النصّ تحوّل إلى أثر وجود. فكلّ ما هو عظيم في التاريخ ترك ظلًا، والظلّ هو البرهان الماديّ على أن النور وُجد.
حين تقول العبارة التي تُختم بها الرواية: (نحن ظلّ الملكات)،
فهي تُقدّم مفهومًا جديدًا للوجود: أن تكون ظلًّا لا يعني أن تكون تابعًا، بل أن تكون أثرًا خالدًا لما مضى من النور.
الظلّ هنا ليس نقيضًا، بل استمرارًا؛ إنه ذاكرة الضوء، كما أن الوعي ذاكرة الوجود.
وهكذا يتحول الرمز من دلالة بصرية إلى فلسفة في البقاء:
الإنسان يفنى، لكن أثره يبقى كظلٍّ للمعنى الذي عاش من أجله. بهذا الفهم، تصبح الرواية تأملًا في خلود الفكرة أكثر من خلود الجسد.
اللغة كفكرٍ جماليّ
في المستوى الفني، تُقدّم الرواية تجربة لغوية فريدة تُعيد الاعتبار للكلمة كجسرٍ بين الفكر والإحساس.
اللغة فيها مشبعة بالإيقاع، لكنها لا تقع في الغنائية المفرطة.
تتوازن الجمل بين البساطة والعمق، وكأنها تكتب على حدّ السكين بين الشعر والفكر.
فحين تصف الكاتبة الخوف بقولها: الخوف ليس ظلامًا، إنه الضوء الذي نراه لأول مرة،
تجمع بين التناقضات في صورةٍ واحدة تجعل القارئ يتأمل المعنى بدل أن يستهلكه.
إنها تمارس نوعًا من الفكر الجمالي الذي يُعيد للكلمة قدسيتها القديمة، حيث لا تكون اللغة وسيطًا بل كائنًا حيًا يحمل الفكر في نَفَسه.
اللغة في ظلّ الملكات ليست محايدة، بل تحمل موقفًا أخلاقيًا وجماليًا في آنٍ واحد؛ فكل استعارة فيها هي أيضًا إعلانٌ فكريّ، وكل وصفٍ هو تحليلٌ فلسفيّ مقنّع.
ولذلك يمكن القول إنّ الرواية تُعيد للكتابة معناها الأصلي: أن تكون أداة فهمٍ للعالم لا تزيينًا له.
الأنوثة بوصفها رؤية فلسفية للوجود
الرواية لا تحتفي بالأنوثة كمجموعة صفاتٍ بيولوجية أو عاطفية، بل تقدّمها بوصفها طريقة في النظر إلى العالم.
الأنوثة عند الكاتبة ليست نقيضًا للذكورة، بل وعيًا بدورة الحياة، ببطء النضج، وبعمق الإحساس بالزمن.
في مشهدٍ رمزي، حين تزرع هاجر شجرة صغيرة أمام المركز وتقول: كل شجرة تبدأ بظلّ صغير، تعلن عن فلسفة الأنوثة التي تقوم على الصبر والتكوين، لا على الانفجار.
هذه النظرة الأنثوية ليست انغلاقًا في الذات، بل انفتاحٌ على العالم عبر الحسّ الجماليّ والتعاطف الإنسانيّ.وهكذا، تُعيد الرواية تعريف القوة من منظورٍ أنثويّ:
القوة ليست في الصدام بل في القدرة على البقاء، ليست في السيطرة بل في الرعاية، ليست في الصراخ بل في الصمت الواعي الذي يعرف متى يتكلم.
الزمن بوصفه حركة وعي
من الناحية البنيوية، لا يتبع الزمن في الرواية ترتيبًا خطيًا، بل يتحرك وفق إيقاع الوعي الداخلي للشخصيات.
الذاكرة، والحلم، والتأمل، تذوب جميعها في نسيجٍ واحد، حتى يغدو الماضي جزءًا من الحاضر.هذا التلاعب الزمني لا يخدم الحبكة فحسب، بل يعكس فلسفة الكاتبة في إدراك الزمن كحركة وعي. فالماضي ليس ما انتهى، بل ما لم يُفهم بعد؛ وكل لحظة من الحاضر تُعيد تشكيله من جديد.
وهكذا يتحول الزمن من إطارٍ خارجيّ للأحداث إلى كائنٍ داخليّ يتحرك في وعي الشخصية، يبطئ حين تتأمل، ويسرع حين تخاف، ويختفي حين تحب.
إنها كتابة ضدّ الزمن الميكانيكيّ، لصالح الزمن الإنسانيّ، حيث يعيش الإنسان في عمق اللحظة لا في تسلسلها.
الرسالة الفلسفية للرواية
تؤكد الرواية، في مجملها، أن الوعي هو الشرط الأول للوجود، وأن الذاكرة هي شكل البقاء الوحيد الممكن.
فلا الخلاص يتحقق بالثورة وحدها، ولا بالحب وحده، بل بالمعرفة التي تمنح الإنسان قدرته على أن يكون ما يفكر فيه.
الإنسان في الرواية ليس ضحية، بل مشروع وعي متحوّل.
كلّ امرأة في النص هي مرآة للوعي الإنساني في مواجهة قهرٍ ما، وكلّ قهرٍ هو فرصة لمعرفة جديدة.
بهذا المعنى، تُصبح ظلّ الملكات كتابًا في الفلسفة الاجتماعية بالاضافة الى كونها رواية أدبية؛ كتابًا عن الإنسان حين يكتب تاريخه بيده، وحين يدرك أن المعنى لا يُمنح بل يُنتزع من الصمت.
الجمال في ظلّ الملكات ليس ترفًا لغويًا، بل ضرورة معرفية؛
والفكر فيها ليس تنظيرًا، بل تجربة شعورية عميقة.
إنها رواية لا تُقدّم المرأة كضحية، بل كفيلسوفة، تُعيد عبر وعيها ترتيب العالم المقلوب.
فالفكر فيها يتنفس من الجمال، والجمال يتغذى من الفكر، حتى تتشكل لوحة أدبية فلسفية تضع القارئ أمام مرآة ذاته:هل نحن النور، أم الظل، أم كلاهما معًا؟
بهذا السؤال الوجوديّ تُغلق الرواية أفقها المفتوح، لتتركنا في مواجهة الحقيقة التي تهرب منها المجتمعات المغلقة:أنّ الحرية ليست حدثًا اجتماعيًا، بل حالة وعي جماليّ وفكريّ، وأنّ من يفكر في الجمال إنما يصنع مقاومة أعمق من كلّ ثورة،
لأن الجمال — كما تقول الرواية في جملتها الأخيرة — هو الذاكرة الوحيدة التي لا تموت.
…
المحور الرابع: الفكر الجمالي والفلسفي في «ظلّ الملكات» — بين الوعي والوجود
إنّ رواية (ظلّ الملكات) لا تنتمي إلى السرد الواقعي البسيط الذي يكتفي بتسجيل التحولات الاجتماعية، بل تتجاوز ذلك إلى أفقٍ فكريّ يجعل من الجمال أداة تفكير، ومن الفن وسيلة لتفكيك الواقع وإعادة صياغته. فهي رواية تتكئ على جمالية الفكر لا على زخرف اللغة، وتستمد عمقها من تأملها في معنى الوجود الإنساني، لا من صخب الأحداث.
فيها تُصبح الحكاية قناعًا للفكرة، والشخصية وسيلة لتجسيد المفهوم، واللغة مختبرًا فلسفيًا يُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم. ولذلك، لا يمكن قراءة (ظلّ الملكات) إلا بوصفها نصًا يستدعي الفلسفة عبر الجمال، ويُمارس الجمال بوصفه تفكيرًا في الوجود.
الجمال كطريق إلى الوعي
منذ الصفحات الأولى، تتجلّى فكرة أن الجمال في الرواية ليس زينة بل وعي متجسد. الكاتبة لا تكتب عن العالم كما هو، بل كما ينبغي أن يُرى، كما لو أنها تريد تطهير الواقع من قبحه بالكتابة.
إنّ السوق المزدحم، الشوارع المتربة، الصمت القاسي — جميعها تُقدَّم بلغةٍ تخلّص القبح من بشاعته عبر الوصف الجمالي، لا لتجميله، بل لإدراك عمقه. فالكتابة الجميلة هنا ليست هروبًا من الواقع، بل مواجهة له بمستوى أرفع من الإدراك.وحين تصف الكاتبة ملامح وجه هاجر وهي تتأمل انعكاسها في زجاج النافذة، لا تقدّم صورةً حسّية، بل تجربة وعي تقول فيها البطلة:لم أرَ نفسي في الزجاج، بل رأيت ما تبقّى مني..
إنّ الجمال في هذه اللحظة ليس مرآة للزينة، بل أداة معرفة؛ فالرؤية الجمالية تُصبح شكلًا من أشكال التفكير في الذات.
الجمال إذن هو وسيلة الرواية لاستعادة ما سُلب من المرأة: حقّها في أن ترى العالم وتعيد تأويله. فالسلطة لا تكتفي بحرمان المرأة من الفعل، بل من النظر أيضًا؛ لأن من يملك الرؤية يملك التفسير.
لهذا تتحول الكتابة إلى فعل بصريّ، إلى استعادة للبصر المسلوب، وكأنّ الكاتبة تقول: أن ترى الجمال، يعني أن تستعيد نفسك من القبح الاجتماعي.
الفكر بوصفه خلاصًا من العدم
في عمق الرواية يسكن سؤالٌ فلسفيّ جوهريّ: ما معنى أن تكون موجودًا؟ هاجر لا تبحث عن الحرية فقط، بل عن معنى وجودها داخل عالمٍ يصرّ على تعريفها من الخارج.
كلّ صمتٍ تواجهه، وكلّ قيدٍ يُفرض عليها، يتحول إلى مادة تفكير؛ لذلك تتخذ الرواية شكل تأملٍ وجوديّ في الحرية والضرورة.
حين تقول البطلة في إحدى لحظات الخذلان:أنا لست ضد العالم، لكني ضد أن أكون صدى له فهي تُعبّر عن جوهر الفلسفة الوجودية: أن تكون الإنسان أصيلًا لا تابعًا، أن تكون فاعلًا لا صدى.إنها تواجه العدم لا بالخوف بل بالوعي؛ فالعدمية في الرواية ليست غيابًا للمعنى، بل لحظة اختبارٍ لمعناه الأعمق.
ومن هذا المنظور، تتحول الرواية إلى رحلة داخل الذات البشرية في بحثها عن الأصالة، عن التوازن بين أن تكون في العالم وأن تبقى نفسك رغم العالم.
الحب بوصفه فعل وعي
على الرغم من أن الرواية مشغولة بالتحرّر الاجتماعي والسياسي، إلا أن الحب فيها يحتل مكانًا جوهريًا بوصفه اختبارًا للوعي لا للعاطفة. فالعلاقة بين هاجر وناصر ليست علاقة حبٍ مأزومة فحسب، بل علاقة فكرين متناقضين يختبران معنى المشاركة الإنسانية.
ناصر يحب هاجر، لكنه لا يعرف كيف يحبّ امرأة تفكّر؛ إنه يحبها ضمن الإطار المألوف الذي يجعل الحب ملكية. أما هي، فترى في الحب مساحة وعيٍ مشترك، لا عقدًا من التبعية.
ولذلك، حين تقول له في لحظة مواجهة:أحبّك، لكني لن أكون مرآتك. تكون قد أعلنت عن أكثر أشكال الحبّ وعيًا: الحبّ الذي يرفض الذوبان في الآخر، ويختار اللقاء على قدم المساواة.
إنّ هذا النوع من الحبّ الفلسفي هو ما يجعل الرواية تتجاوز التناقض المألوف بين الذات والآخر، لتقدّم نموذجًا للعلاقة الإنسانية الناضجة، حيث المحبة فعل وعيٍ متبادل، لا علاقة قوة.وهكذا يتحوّل الحب في الرواية إلى معادل فلسفي للحرية: كلاهما لا يعيش إلا حين يُمارَس بوعي.
الفلسفة الوجودية في البناء السردي
تُبنى الرواية وفق منطقٍ يذكّر بالقواعد الوجودية في الفكر الحديث:
الذات في مواجهة العالم، الحرية في مواجهة الضرورة، الذاكرة في مواجهة النسيان،المعنى في مواجهة العدم.كلّ مشهدٍ سرديّ هو تمرينٌ على هذا الصراع الداخلي.
في لحظةٍ من العزلة، تقول هاجر وهي تتأمل المدينة من نافذتها:
كلّ هذه الأضواء تخاف من الظلام الذي فيها.. بهذه الجملة القصيرة، تختصر الكاتبة فكرة أن الضوء نفسه ليس نقيض العتمة بل ابنها، وأن الإنسان لا يكتمل إلا حين يواجه ظله الداخلي.
إنها فكرة مستمدة من عمق الفلسفة الوجودية كما صاغها كيركغارد وسارتر، لكنها تُعاد صياغتها في الرواية بلغةٍ أدبية رقيقة تذيب الفلسفة في الشعر.
الظلّ بوصفه استعارة وجودية
من الناحية الجمالية، يُمكن اعتبار «الظل» محورًا فلسفيًا للرواية.
الظلّ في الوعي المألوف علامة غياب، لكنه في النصّ تحوّل إلى أثر وجود. فكلّ ما هو عظيم في التاريخ ترك ظلًا، والظلّ هو البرهان الماديّ على أن النور وُجد.
حين تقول العبارة التي تُختم بها الرواية: «نحن ظلّ الملكات»،
فهي تُقدّم مفهومًا جديدًا للوجود: أن تكون ظلًّا لا يعني أن تكون تابعًا، بل أن تكون أثرًا خالدًا لما مضى من النور.
الظلّ هنا ليس نقيضًا، بل استمرارًا؛ إنه ذاكرة الضوء، كما أن الوعي ذاكرة الوجود.وهكذا يتحول الرمز من دلالة بصرية إلى فلسفة في البقاء:
الإنسان يفنى، لكن أثره يبقى كظلٍّ للمعنى الذي عاش من أجله.
بهذا الفهم، تصبح الرواية تأملًا في خلود الفكرة أكثر من خلود الجسد.
اللغة كفكرٍ جماليّ
في المستوى الفني، تُقدّم الرواية تجربة لغوية فريدة تُعيد الاعتبار للكلمة كجسرٍ بين الفكر والإحساس.اللغة فيها مشبعة بالإيقاع، لكنها لا تقع في الغنائية المفرطة.تتوازن الجمل بين البساطة والعمق، وكأنها تكتب على حدّ السكين بين الشعر والفكر.
فحين تصف الكاتبة الخوف بقولها: «الخوف ليس ظلامًا، إنه الضوء الذي نراه لأول مرة»،تجمع بين التناقضات في صورةٍ واحدة تجعل القارئ يتأمل المعنى بدل أن يستهلكه.
إنها تمارس نوعًا من الفكر الجمالي الذي يُعيد للكلمة قدسيتها القديمة، حيث لا تكون اللغة وسيطًا بل كائنًا حيًا يحمل الفكر في نَفَسه.
اللغة في «ظلّ الملكات» ليست محايدة، بل تحمل موقفًا أخلاقيًا وجماليًا في آنٍ واحد؛فكل استعارة فيها هي أيضًا إعلانٌ فكريّ، وكل وصفٍ هو تحليلٌ فلسفيّ مقنّع.ولذلك يمكن القول إنّ الرواية تُعيد للكتابة معناها الأصلي: أن تكون أداة فهمٍ للعالم لا تزيينًا له.
الأنوثة بوصفها رؤية فلسفية للوجود
الرواية لا تحتفي بالأنوثة كمجموعة صفاتٍ بيولوجية أو عاطفية، بل تقدّمها بوصفها طريقة في النظر إلى العالم. الأنوثة عند الكاتبة ليست نقيضًا للذكورة، بل وعيًا بدورة الحياة، ببطء النضج، وبعمق الإحساس بالزمن.
في مشهدٍ رمزي، حين تزرع هاجر شجرة صغيرة أمام المركز وتقول: «كل شجرة تبدأ بظلّ صغير»،
تعلن عن فلسفة الأنوثة التي تقوم على الصبر والتكوين، لا على الانفجار.هذه النظرة الأنثوية ليست انغلاقًا في الذات، بل انفتاحٌ على العالم عبر الحسّ الجماليّ والتعاطف الإنسانيّ.
وهكذا، تُعيد الرواية تعريف القوة من منظورٍ أنثويّ:
القوة ليست في الصدام بل في القدرة على البقاء، ليست في السيطرة بل في الرعاية، ليست في الصراخ بل في الصمت الواعي الذي يعرف متى يتكلم.
الزمن بوصفه حركة وعي
من الناحية البنيوية، لا يتبع الزمن في الرواية ترتيبًا خطيًا، بل يتحرك وفق إيقاع الوعي الداخلي للشخصيات.الذاكرة، والحلم، والتأمل، تذوب جميعها في نسيجٍ واحد، حتى يغدو الماضي جزءًا من الحاضر.هذا التلاعب الزمني لا يخدم الحبكة فحسب، بل يعكس فلسفة الكاتبة في إدراك الزمن كحركة وعي.
فالماضي ليس ما انتهى، بل ما لم يُفهم بعد؛ وكل لحظة من الحاضر تُعيد تشكيله من جديد.وهكذا يتحول الزمن من إطارٍ خارجيّ للأحداث إلى كائنٍ داخليّ يتحرك في وعي الشخصية، يبطئ حين تتأمل، ويسرع حين تخاف، ويختفي حين تحب.
إنها كتابة ضدّ الزمن الميكانيكيّ، لصالح الزمن الإنسانيّ، حيث يعيش الإنسان في عمق اللحظة لا في تسلسلها.
الرسالة الفلسفية للرواية
تؤكد الرواية، في مجملها، أن الوعي هو الشرط الأول للوجود، وأن الذاكرة هي شكل البقاء الوحيد الممكن.
فلا الخلاص يتحقق بالثورة وحدها، ولا بالحب وحده، بل بالمعرفة التي تمنح الإنسان قدرته على أن يكون ما يفكر فيه.
الإنسان في الرواية ليس ضحية، بل مشروع وعي متحوّل.
كلّ امرأة في النص هي مرآة للوعي الإنساني في مواجهة قهرٍ ما، وكلّ قهرٍ هو فرصة لمعرفة جديدة.
بهذا المعنى، تُصبح «ظلّ الملكات» كتابًا في الفلسفة الاجتماعية أكثر منها رواية أدبية؛ كتابًا عن الإنسان حين يكتب تاريخه بيده، وحين يدرك أن المعنى لا يُمنح بل يُنتزع من الصمت.
الجمال في «ظلّ الملكات» ليس ترفًا لغويًا، بل ضرورة معرفية؛
والفكر فيها ليس تنظيرًا، بل تجربة شعورية عميقة.
إنها رواية لا تُقدّم المرأة كضحية، بل كفيلسوفة، تُعيد عبر وعيها ترتيب العالم المقلوب.
فالفكر فيها يتنفس من الجمال، والجمال يتغذى من الفكر، حتى تتشكل لوحة أدبية فلسفية تضع القارئ أمام مرآة ذاته:هل نحن النور، أم الظل، أم كلاهما معًا؟
بهذا السؤال الوجوديّ تُغلق الرواية أفقها المفتوح، لتتركنا في مواجهة الحقيقة التي تهرب منها المجتمعات المغلقة:
أنّ الحرية ليست حدثًا اجتماعيًا، بل حالة وعي جماليّ وفكريّ،
وأنّ من يفكر في الجمال إنما يصنع مقاومة أعمق من كلّ ثورة،
لأن الجمال — كما تقول الرواية في جملتها الأخيرة —
هو الذاكرة الوحيدة التي لا تموت.
خاتمة
تغلق ظلّ الملكات قوسها السردي لا بإجابةٍ نهائية، بل بسؤالٍ وجوديّ عميق يجعل القارئ شريكًا في فعل التأمل، لا متلقيًا للحكاية. إنها رواية تكتب الإنسان في لحظة مواجهته لظله، وتعيد الاعتبار للوعي كقوةٍ قادرة على أن تُعيد تشكيل العالم من الداخل. كلّ مشهدٍ فيها يتحوّل إلى مرآةٍ للذاكرة، وكلّ صوتٍ نسويّ إلى ترجمةٍ لصمتٍ إنسانيّ طويل، كأنّ الكاتبة أرادت أن تقول إنّ التاريخ الحقيقي يبدأ من لحظة النطق الأولى، حين يختار المقموع أن يتكلم لا ليُسمع، بل ليكون.
يظهر في عمق النص أن الحرية لا تُمنح من الخارج، ولا تأتي عبر الصراع المسلّح أو البيان السياسي، بل تولد من القدرة على الوعي بالذات. فالفعل الحقيقي يبدأ حين تكتشف المرأة – والإنسان عمومًا – أن الصمت لم يكن قدرًا، بل صناعة بشرية، وأن مقاومته لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى فكرة راسخة كجذرٍ في تربةٍ عميقة. الرواية لا تبحث عن الانتصار، بل عن المعنى، ولا تدافع عن جنسٍ ضد آخر، بل عن الكائن الإنساني في جوهره حين يستعيد صوته الذي صادرته السلطة والخوف.
تمارس الكاتبة في نصّها فعل تحريرٍ مزدوج: تحرير اللغة من البلادة، وتحرير الإنسان من الصمت. فالكلمة في الرواية ليست وسيلة نقلٍ للحكاية، بل كائن حيّ يتنفس في المعنى ويقاوم الزوال. كلّ جملة تُكتب لتستعيد منسيًّا، وكلّ استعارة تفتح بابًا على الذاكرة. هكذا تغدو الكتابة نفسها فعلاً وجوديًا، مقاومة بالحبر في وجه تاريخٍ كُتب بالحذف والتشويه. اللغة هنا ليست زخرفًا بل وعيًا جماليًا، تتحرك بين الفكرة والإحساس ككائنٍ شفاف يرى بعين القلب قبل البصر.
في هذا الفضاء السردي، تتبدّل مفاهيم الظلّ والنور، القوة والضعف، الصمت والكلام. الظلّ لم يعد نقيضًا للنور، بل أثره الباقي، ذاكرته التي لا تُمحى. والأنوثة لم تعد قالبًا اجتماعيًا، بل طريقة في الفهم والرؤية، تمزج الرهافة بالقوة، والصبر بالفعل، والحنين بالمعرفة. المرأة في الرواية لا تطلب المساواة لأنها تعلم أن المساواة مفهوم ناقص أمام الكمال الإنساني، بل تطلب الحق في أن تكون كما هي، كائنًا واعيًا، محبًا، صانعًا للمعنى، حافظًا للذاكرة. وهكذا تتجاوز الرواية حدودها النسوية إلى أفقٍ إنسانيّ أوسع، حيث تتحول التجربة الأنثوية إلى مرآةٍ للعالم بأسره.
الرواية تُنصت إلى التاريخ لا لتكرّره، بل لتصحّحه، وتُنصت إلى الجرح لا لتتغنّى به، بل لتجعله بداية شفاء. الذاكرة فيها ليست ألبومًا من الماضي، بل مادة خلقٍ جديدة، تُستعاد لتصنع وعيًا مختلفًا بالمستقبل. فكلّ تذكّر في الرواية هو شكل من أشكال المقاومة، وكلّ حكاية تُروى هي فعل حضورٍ في وجه النسيان. لذلك يصبح السرد نفسه شكلًا من أشكال العدالة؛ لأن الكلمة التي تُقال بعد زمنٍ من المنع تُعيد للوجود توازنه المفقود.
أما الجمال في النص، فهو ليس ترفًا لغويًا، بل ضرورة وجودية. الجمال في «ظلّ الملكات» يشبه النور الذي لا يقهر الظلام بل يكشفه، ويمنحه معنى. إنه الجمال الذي يُطهّر الألم من عشوائيته ويمنحه شكلاً من الفهم، الجمال الذي يجعل من الوجع طريقًا للمعرفة. كلّ صورة في الرواية مشغولة بعنايةٍ تأملية، كأن الكاتبة تصوغ من اللغة معبدًا صغيرًا للروح، تُصلّي فيه الكلمة على نية المعنى.
إن الرواية لا تقدّم خلاصًا حاسمًا، بل وعيًا متحوّلًا يدعو إلى التأمل. إنها نصّ يتجاوز الحكاية ليصير تجربة فكرية وجمالية، تُعلّم القارئ كيف يُنصت، وكيف يُفكّر، وكيف يُحبّ دون أن يفقد ذاته. فكل ظلّ فيها يُشير إلى ضوء، وكل فقدٍ يُفضي إلى معرفة، وكلّ خيبةٍ تُثمر معنى.
إن ظلّ الملكات ليست رواية عن نساءٍ منسيات، بل عن الإنسان حين يتذكّر نفسه بعد طول غياب. إنها بيانٌ جماليّ ضد العدم، واحتفاءٌ هادئ بالمعرفة التي تُنقذ الوجود من العمى.
وحين تُغلق صفحاتها الأخيرة، تبقى الجملة التي تختصر جوهرها كله ترفرف كنبضٍ أخير: ليس في الظلّ ما يُخيف، لأن النور لا يُرى إلا حين يعترف بظلّه.